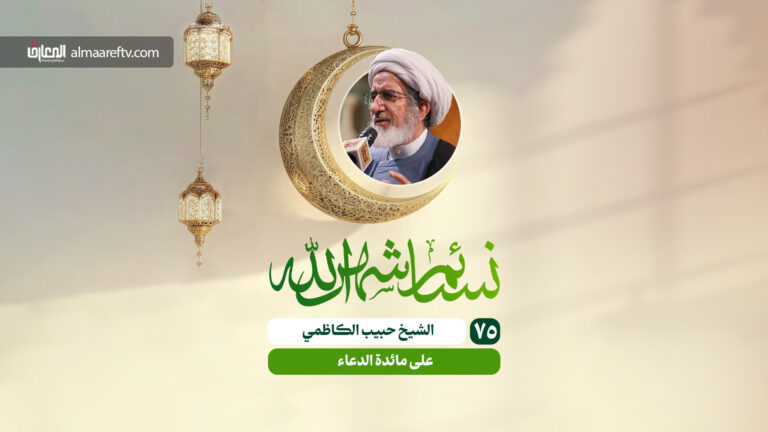حث الإسلام على العمل – د. الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله
يحدثنا القرآن الكريم عن مشهد من مشاهد الجحود والتكبر، في قوله تعالى:
﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالا وَوَلَدًا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾.
وقد نزلت هذه الآية في واحد من صناديد قريش، إما العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة، حين جرى بينه وبين الصحابي الجليل الخبّاب بن الأرت (رضوان الله عليه) حديث عجيب.
فقد كان الخباب يعمل في صياغة الذهب، فلما فرغ من عمل حلية لأحدهم طلب أجره، فأبى إلا أن يرجئ الدفع بشرط أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وآله.
فردّ الخباب بثبات المؤمن: “لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث”. فردّ ذلك المتكبر: “إذا متّ ثم بُعثت، جئتني ووجدت عندي مالاً وولداً فأعطيتك”. فنزل الوحي الإلهي مبطلاً وهمه، ومكذّباً مزاعمه.
العمل في ميزان الإسلام:
هذه القصة تكشف عن بُعد عميق في رسالة الإسلام: أن العمل شرف، وأن السعي في طلب الرزق عبادة. فالخبّاب – وهو من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ومن أنصار أمير المؤمنين (ع) – لم يكن يعيش على البطالة أو التطفل، بل كان صائغاً يكسب بيده.
وهنا تتجلى قيمة الإسلام في رفع مكانة العمل المهني والتجاري، خلافاً لما كان عليه العرب قبل الإسلام حيث اعتادوا الغزو والسطو طلباً للرزق، واعتبروا المهن اليدوية دناءة.
بل حتى الأمم الكبرى كالرومان، وإن كانوا يعظمون الفكر والفلسفة، إلا أنهم كانوا يحتقرون الأعمال اليدوية. فجاء الإسلام بمنهج متوازن، يرفع قيمة اليد الكادحة كما يرفع قيمة الفكر المبدع، فلا فضل لهذا على ذاك إلا بالتقوى والإخلاص.
بين الإسلام والفكر المادي:
ولعل من الطريف أن نلحظ المفارقة مع الفلسفات الحديثة كالماركسية، التي عظّمت العمل اليدوي واحتقرت العمل الفكري، فجعلت العامل والفلاح “منتجين”، بينما الأستاذ والمفكر “غير منتج”. غير أن الحقيقة أن الأستاذ هو المنتج الأول، فهو الذي يخرّج العلماء والأطباء والمهندسين وسائر الكفاءات. بهذا يتبين أن الإسلام، بخلاف الفكر المادي، جمع بين الطرفين، ورأى أن كل عمل نافع – يدوياً كان أو فكرياً – هو شريف إذا اقترن بالنية الصالحة.
المال والبنون… زينة أم ابتلاء؟
وقد ركزت الآيات الكريمة على رمزين من رموز الدنيا: المال والبنون، فقال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾.
والإنسان بفطرته لا يستغني عنهما؛ فمن كان غنياً بلا ولد، يعيش ناقص السعادة لأنه بلا امتداد يحمل اسمه.
ومن كان له ولد ولا مال له، يظل يجري وراء رزقه ليؤمن مستقبلهم. لكن الإسلام علّمنا أن المال والولد لا قيمة لهما إذا كانا بعيدين عن رضا الله، وأن السعادة الحقّة هي في العمل الصالح والرزق الحلال.
الغيب واليقين بالمعاد:
أما قول المتكبر: “سيكون لي مال وولد بعد البعث”، فقد ردّه القرآن باستفهام تقريعي: ﴿أَطَّلَعَ الْغَيْبَ﴾. أي أأصبح يعلم الغيب بغير إذن الله؟ إن الغيب لله وحده، لا يطلع عليه أحد إلا من ارتضى من رسله وأوصيائه لحكمة بالغة. فكيف يدّعي الكافر ما لا يملك برهاناً عليه؟
الخلاصة:
إن الإسلام حارب البطالة والاتكالية، ودعا إلى أن يكون الإنسان عاملاً منتجاً، يده بيد الناس، وعرقه في سبيل العيش الكريم. فالعمل عبادة إذا نوى به الإنسان وجه الله، واليد الكادحة أحب إلى الله من اليد المتسولة. وهكذا يصبح الرزق الحلال وسيلة لعمارة الدنيا، ومزرعة للآخرة، وزاداً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.