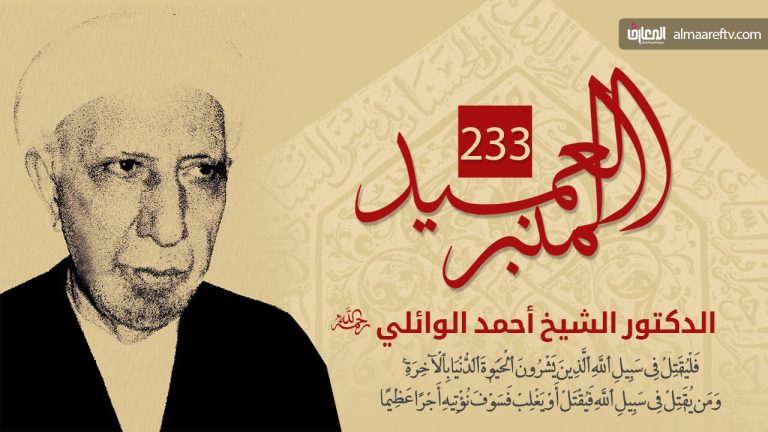الأقوام السابقين – د. الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله
(قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون)
هناك مفردات وألفاظ في القرآن الكريم إن لم يكن القارئ لها والمتمعن فيها عالما بأحكام لغتها وعريقا في ذلك لم يستطع استنباط المعنى المطلوب والمقصود منها.
والقرآن الكريم ليس مجرد كلمات وألفاظ ومعان بل هو شيء خلف المعنى، وهي ألفاظ حية تعيش معنا وتحيا كل ما قرأنها وتلوناها.
ومن ذلك آية (فلما تغشاها حملت حملا خفيفا)، فاستخدام كلمة (تغشى) هي من بديع البيان وجميله، وهي تشير إلى الحالة التي تعتري الرجل وزوجه والتمازج الحاصل بينهما، وهي أبلغ من قول التقاها أو لقيها. كما أن هناك فرقا بين الحمل بالفتح والحمل بالكسر، فالأولى تعني ما يحمل بداخل البطن، والثانية تعني ما يحمل فوق الظهر.
كما أن هناك عدة معان للكلمة الواحدة، فكلمة صلاة لها ثلاثة معان؛ شرعي ولغوي وعرفي، فأما المعنى الشرعي فهو الصلاة التي نعرفها التي نبدأ بالنية والتكبير ثم قراءة الحمد والسورة والركوع والسجود وما إلى ذلك.
أما المعنى اللغوي للصلاة فهو الدعاء، فمن وقف داعيا فهو مصل بالمعنى اللغوي. أما المعنى العرفي فهو يحمل كلا المعنيين.
وكذلك الحال في كلمة ولد، فلو أن شخصا أوصى في وصيته قائلا: أعطوا أموالي لأولادي، ولهذا الشخص ذرية من ذكور وإناث، فعلى أي معنى نحمل قوله؟
فلو جئنا إلى المعنى الشرعي فهو يعتبر الولد هو من جاء من أبوين بعقد شرعي، ومن ولد بعقد غير شرعي فقد يسمى ولدا لكنه لا يحصل على شيء من الميراث.
أما المعنى اللغوي لكلمة ولد فهو ما ولده الأبوان سواء كان المولود ذكرا أم أنثى.
أما بناء على المعنى العرفي فالولد هو المولود الذكر وحده دون الأنثى، ففي تعبيرنا نطلق كلمة ولد على الذكر وبنت على الأنثى، ولا نعمم كلمة ولد على كليهما.
وعندما يأتي الفقهاء إلى مثل هذه الحالة فهم يأخذون بالمعنى العرفي لأنه المعنى السائد بين الناس. والقرآن الكريم كذلك جاء ليحدث الناس بلسانهم، لذلك فإن الفقهاء عادة ما يحملون القرآن على المعنى العرفي دون اللغوي أو الشرعي.
إن الأقوام السابقين كانوا يمكرون ويحاولون التحجج دوما بحجج واهية للتملص من الهداية والإيمان بالأنبياء والرسل، فكانوا مثلا يقولون لماذا حرم الله الربا وأحل البيع، فكما أنني أربح من البيع كذلك أنا أربح من الربا، رغم الفرق بين الأمرين.
كما يحاول بعضهم أن يعترض على تحريم الزنا فيقول ما الفرق بين أن أتزوج أو أزني، فعندما أزني برضا المرأة فليس في هذا إشكال وهو كالزواج، لكن الفرق واضح بين الأمرين لأن الزواج فيه التزام وفيه عقد يلزم الرجل بعدة أمور ويلزم المرأة بأمور أيضا، أما الزنا فهو مجرد تفريغ شهوة عابرة وعدم تحمل تبعات ذلك من ولادة قد تحدث فيخرج الولد تائها لا يعرف أباه أو أمه فيتحول إلى مجرم أو عنصر سيئ في المجتمع.
وقد جاء رجل ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يسلم لكنه أخبره بأن يعفيه من أمر واحد لا يقدر على تركه وهو الزنا، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله بأنه هل يقبل بذلك على أخته وأمه وقريباته؟ فأجاب بالنفي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله كيف تقبل بذلك على نساء الآخرين وأن تأباه لنفسك؟ فاقتنع الرجل وتاب ودخل الإسلام.
تريد هذه الآية الإشارة إلى أن الأقوام السابقين هم كقوم النبي صلى الله عليه وآله كانوا يخترعون الكثير من الحجج ليبقوا على ضلالهم وكفرهم في حال اصطدمت الشريعة بمصالحهم وأهوائهم.
كما تريد الآية تسلية قلب النبي صلى الله عليه وآله بإخباره أن قومه هم كالأقوام السابقين وليسوا بشيء جديد، فالأقوام السابقين كانوا على هذه الشاكلة من العناد والإصرار على الكفر والضلال.
ويقول الله لنبيه بأن هذا الطريق ليس معبدا، وطريق إصلاح الناس طريق محفوف بالمشاكل والصعاب، وإن هداية الأقوام السابقين لم تتم إلا بعد معاناة طويلة، وهكذا كانت مسيرة النبي صلى الله عليه وآله كمسيرة أسلافه من الأنبياء مع الأقوام السابقين، بل قال النبي صلى الله عليه وآله (ما أوذي نبي مثل ما أوذيت).
كما تخبر الآية قريشا وقوم النبي صلى الله عليه وآله بأنهم ليسوا بعيدين عن عذاب الله، والله يستطيع أن يعذبهم كما عذب الأقوام السابقين من قبلهم.
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم أصحابه بما سيؤول إليه حال المسلمين في المستقبل، فقال لهم إنهم سيكونون ذات يوم في ضعف ووهن شديد تتداعى عليهم الأمم فسألوه أمن قلة فينا يا رسول الله؟ فقال لهم لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل.
وهذا حال أغلب المسلمين اليوم لا يحملون من الإسلام إلا اسمه ولا يطبقون شيئا من تعاليمه السمحاء ويفعلون كل المنكرات وما نهى الله عنه ثم يسمون أنفسهم مسلمين.
وتخبر الآية عن حال الأقوام السابقين حيث عذبهم الله لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر، ولكي يكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم فيأخذ الدروس مما تعرضوا إليه، ولكن هل من متعظ؟