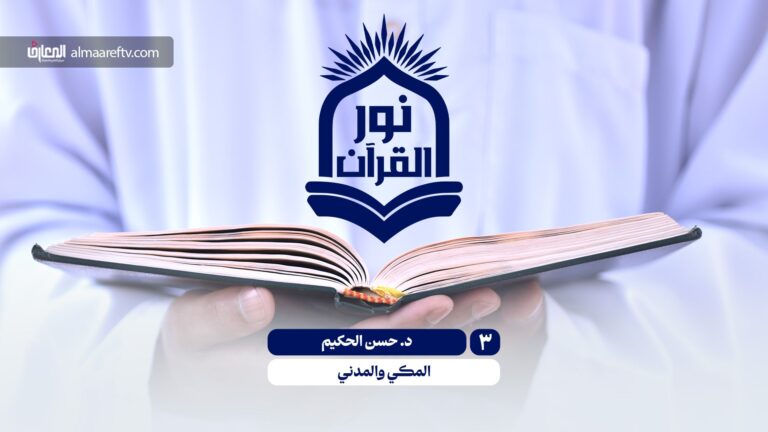نعم الله تعالى بين الظهور والخفاء – د. الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله
قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ “لقمان: 20”
يقدم النص القرآني في هذه الآية رؤية شاملة لطبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق، من خلال مفهوم “التسخير” و”الإسباغ”، كعلامتين على النعمة.
فالله عز وجل لم يكتفِ بخلق الإنسان، بل هيّأ له كل عناصر البقاء والتطور، وسخّر له ما في السماوات وما في الأرض، ثم أسبغ عليه نعمه، أي عمّها ووسعها حتى أحاطت به من كل جانب.
النعمة والوعي الفطري
الهدف من هذا التذكير الإلهي ليس فقط لبيان العطاء، بل لإحياء الشعور الفطري بالامتنان، ذلك الشعور الذي يتجلى في عبادة المنعِم وشكره. وليس الشكر هنا فعلًا لفظيًا، بل هو موقف وجودي يتمثل في طاعة الله، والتسخير السليم للنعم، وعدم استعمالها في معصيته.
فالآية تقرر أن النعمة ليست منّة عارضة، بل هي أصل ثابت في علاقة الله بعباده، مما يجعل الإنسان مسؤولًا عن موقفه منها، وملزمًا بإدراك حدودها وغاياتها.
النعم الباطنة والظاهرة: تفكيك المفهوم
اختلف المفسرون في تفسير النعم الظاهرة والباطنة، فذهب البعض إلى أن الظاهرة هي ما يُرى بالعين من صحة، ومال، وولد، وأمن… بينما الباطنة تشمل العقل، والمعرفة، والإيمان، وما يجري في باطن النفس من الهداية إلى الخير، والطمأنينة، وقوة الإرادة.
غير أن هذا التقسيم ليس مجرد توصيف بياني، بل هو تأسيس لمنهج في فهم النعمة، فالإنسان الذي يدرك أن العقل نعمة، والعلم نعمة، والإيمان نعمة، سيتعامل معها على أساس المسؤولية لا على أساس الاستحقاق المجرد.
فالعقل – مثلًا – لا يُشكر بحفظه فقط، بل بتفعيله في ميادين العلم والمعرفة، وتسخيره لما فيه مصلحة الإنسان والمجتمع. بل أكثر من ذلك، أن تُصان هذه الملكة من التلوث بالهوى، والتعصب، وسوء الفهم.
العلاقة بين الشريعة والعلم
من أوسع النعم التي أُسبغت على الإنسان، نعمة التشريع الإلهي.
فالشرائع السماوية، كما يقرر بعض المفسرين، تدخل ضمن دائرة “النعم الظاهرة”، إذ إنها تمثل إطارًا ينظم السلوك، ويهذب الغريزة، ويمنع طغيان الإنسان على نفسه وعلى غيره.
والحكمة في هذا المعطى أن العلم وحده لا يكفي. فالتاريخ الحديث، كما القديم، شهد عصورًا كان فيها التقدم العلمي في ذروته، لكنه لم يمنع الحروب ولا الانحلال.
لذلك كانت الشريعة ضرورة، لا بديلًا عن العقل، بل موجهة له ومهذبة لإفرازاته. فكل علم لا يصب في خدمة القيم، يتحول إلى أداة دمار وإنحراف، مهما ادعى أصحابه الموضوعية والتقدم.
جدلية الجحود والنكران
ورغم وضوح النعم في حياة الإنسان، تنتهي الآية ببيان ظاهرة الجدل العقيم: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾
إنه جدال لا يقوم على فهم، ولا يرتكز إلى وحي، ولا يستند إلى مصدر معرفي موثوق. وهذا النوع من المجادلة لا يمثل وجهة نظر قابلة للنقاش، بل يعكس أزمة أخلاقية ومعرفية، مردّها إلى جحود النعمة، ورفض الاعتراف بالمُنعِم.
خاتمة
النعمة ليست مجرد رزق يتدفق، بل هي منظومة وجودية متكاملة تشمل الجسد والفكر والروح. والإنسان حين يعي هذا المفهوم، يدرك أن كل ما بين يديه من قدرة وإمكان هو أمانة، يجب أن تدار بعقل، وتُوجَّه بشريعة، وتُشكر بالفعل لا بالقول فقط.